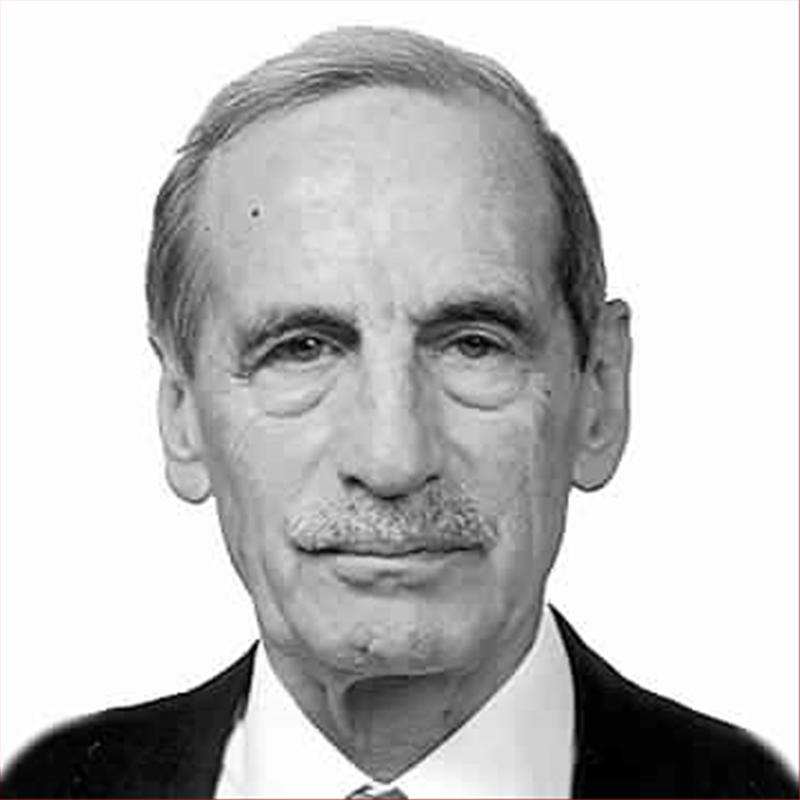لروسيا أيضاً دور في التراجع الميداني لقوات الأسد؟

بدأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ومساعدوه لقاءاتهم مع أطراف الصراع في سورية. يأتي هذا التحرك الجديد على وقع «الأغاني الوطنية» التي أحلّها النظام في دمشق محل البرامج المنوعة، إثر الانتكاسات التي مني بها في شمال غربي البلاد وجنوبها. ويأتي إثر فشل لقاء «موسكو 2» الذي لم يحرك قطار الحل السياسي خطوة إلى الأمام. ويأتي عشية القمة الأميركية - الخليجية. أما النتائج فلن تظهر إلا مع نهاية حزيران (يونيو) المقبل، المهلة الأخيرة لإبرام اتفاق نووي بين إيران والدول الخمس الكبرى وألمانيا. وهو موعد بات كثير من الاستحقاقات في المنطقة العربية مرتبطاً به ارتباطاً مباشراً. من مستقبل «عاصفة الحزم» و «إعادة الأمل» في اليمن، إلى مصير «جنيف 3» وإمكان تحريك عاصفة مشابهة في سورية. ومن مسار الحرب على «داعش» في العراق ومستقبل الوضع السياسي في هذا البلد، إلى مستقبل الانتخابات الرئاسية في لبنان على وقع قرقعة السلاح استعداداً لموقعة القلمون... وربما مستقبل انخراط «حزب الله» في الحرب السورية. في اليمن يرفع التحالف العربي ورقة العودة إلى طاولة الحوار في الرياض برعاية مجلس التعاون. لكنه لم يعلق «عاصفة الحزم» أداة ضغط متواصلة لتحقيق ما لم تحققه الديبلوماسية بين القوى المختلفة المعنية بأزمة اليمن. وفي العراق يحتدم النقاش حول دور «الحشد الشعبي» بميليشياته الشيعية وإدارته الإيرانية في تحرير المحافظات. وتغذيه المخاوف من احتمال مد الولايات المتحدة المكونين الكردي والسني بالسلاح اللازم من دون العودة إلى بغداد وحكومتها المركزية. ليس في الحدثين جديد طارئ كما هي حال الأزمة السورية التي شهدت في الأسابيع الأخيرة تحولات ميدانية تنذر بقلب المعادلة العسكرية وميزان القوى على الأرض لمصلحة الفصائل المسلحة المعارضة التي باتت تطرق أبواب الساحل في ريف اللاذقية التي تحتضن كتلة سنية وازنة حولت الخريطة الديموغرافية في هذا الساحل لمصلحة هذه الكتلة. أكثر من عامل حرك جبهات الحرب في سورية. بينها التحالف العربي الجديد الذي أرسى تفاهمات بين بعض «أصدقاء سورية»، خصوصاً السعودية وقطر وتركيا والأردن، انعكست تفاهمات على الأرض بين فصائل متناحرة ومتنافسة. وانضمام وحدات تلقت تدريبات خارج سورية إلى هذه الفصائل. وتبدل المزاج الأميركي بعدما حض الرئيس باراك أوباما العرب على التحرك كما فعلوا في اليمن. وبينها أيضاً انشغال ميليشيات تدعمها إيران بالحرب على «داعش» في العراق. فضلاً عن انشغال طهران نفسها بتطورات الوضع اليمني، ومحاولة شد إزر الحوثيين وحلفائهم. إلى كل هذه الاعتبارات ثمة مؤشرات إلى تغير في مزاج روسيا: لم تعد تحتمل اقتصادياً. تعاني مثلها مثل الجمهورية الإسلامية. فعلت العقوبات وتدني أسعار الطاقة وخروج الاستثمارات الخارجية فعلها. ومن الطبيعي أن يترك ذلك أثره على الدعم الذي تقدمه إلى دمشق. ربما باتت روسيا أكثر اهتماماً بإعادة النظر في موقفها بعد أربع سنوات من الوقوف إلى جانب النظام. وما يشجعها على ذلك إدراكها عبر مبعوثيها أن القيادة السورية لا تملك صورة عما قد يؤول إليه الوضع. وكانت ولا تزال تراهن على الحسم العسكري. وترفض مجرد البحث في أي تسوية سياسية. وبدت في الأسابيع الأخيرة عاجزة أمام تقدم المعارضة. وتعاند في التقدم ولو خطوة بسيطة في اتجاه المعارضة الداخلية، أو ما تسميه «المعارضة الوطنية». في حين كانت أصوات تتعالى في الساحل السوري معترضة وناقمة بعد الخسائر التي منيت بها المؤسسة العسكرية المنهكة بكل فروعها باعتراف الأسد نفسه. فيما يضرب الفساد عميقاً في نواح ومستويات عالية في هياكل السلطة، خصوصاً في صفوف قوات «الدفاع الوطني» حيث وصل الأمر إلى حد المواجهة الميدانية بينها وبين الجيش النظامي. كما حدث في حمص حيث تحاول الميليشيات إحباط أي هدنة ليستمر استغلالها للحصار وبوابات العبور! ولاحظت دوائر معنية أن الكرملين لم يخف انزعاجه من موقف وفد الحكومة السورية الذي حضر لقاءات «موسكو 2» الأخيرة مع بعض الوجوه المعارضة. وترجم هذا الانزعاج تخلفاً في مد الجيش السوري ببعض الشحنات من ذخائر وعتاد، وإن عاد إلى وتيرته السابقة أخيراً. وهو ما دفع ربما وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج إلى زيارة طهران التي بدورها قلصت من دعمها المالي، ولم تعد قادرة، كما في السابق، على توفير كل ما تحتاج إليه آلة النظام. إلى كل هذه الاعتبارات، تخشى موسكو أن تستأثر طهران بالورقة السورية كاملة. وما يقلقها أن تستخدم هذه الورقة على طاولة الحوار مع واشنطن إذا قيض للاتفاق النووي أن يرى النور نهاية الشهر المقبل. ولا شك في أن روسيا ترى إلى سورية حليفاً تاريخياً لا غنى عنه في قلب الشرق، سواء عبر القاعدة البحرية في طرطوس، أو عبر العلاقة العضوية مع الجيش السوري وترسانته من السلاح الشرقي. وهي تخشى أن تحقق المعارضة العسكرية مزيداً من المكاسب على الأرض بعدما باتت تطرق حدود الساحل من بوابة اللاذقية. مثلما تخشى أن تتصاعد الدعوات إلى قيام مناطق آمنة، مثلما ألح رئيس «الائتلاف الوطني» خالد خوجه في لقاءاته بواشنطن أخيراً. ومثلما تلح تركيا وآخرون. لا يعني هذا التبدل أن روسيا تخلت عن الرئيس الأسد، أقله في المدى المنظور. لكنها قد تكون معنية بالتحرك الجديد للمبعوث الدولي الذي يسعى إلى إحياء ما نص عليه بيان «جنيف 1». متابعون لحركة الداخل السوري يتحدثون عن رغبتها مجدداً في إثارة موضوع المرحلة الانتقالية من ستة أشهر يظل فيها الرئيس الأسد على رأس السلطة، بينما تنتقل صلاحياته إلى حكومة مشتركة من أبناء النظام والمعارضة، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية يفترض أن تنتهي بطي صفحة الأسد، لكنها تحافظ على ما بقي من هياكل الدولة، لئلا تتكرر تجربة العراق. وليس مؤشراً عابراً أن تمرر موسكو في مجلس الأمن القرار 2216. ساهمت في تقديم غطاء شرعي لـ «عاصفة الحزم»، مع ما يعنيه من إغضاب لحليفها الإيراني، وتسليف للسعودية وأطراف التحالف العربي الجديد. وهي على علاقة جيدة مع مصر والأردن. وتعي جيداً أن بعض العرب المتوجسين بالتقارب بين واشنطن وطهران يسعى إلى حلفاء في صفوف القوى الكبرى يمكن الاعتماد عليهم كفرنسا والصين وروسيا لتعويض ما قد يفتقده من الانسحاب أو التخلي الأميركي. مع هذا التوجه الروسي نحو تمتين العلاقات مع التحالف العربي الجديد وما يولده من تنسيق في مجالات عدة أبرزها أسعار الطاقة وأسواقها، يعلق سيد الكرملين أهمية كبيرة على بناء علاقات وثيقة مع رجب طيب أردوغان. فالرئيس التركي يعاني مثله من متاعب مع أوروبا التي بات شبه مقتنع بأنها لا تريده عضواً في اتحادها. ويمكن البلدين أن ينطلقا من مصالحهما الواسعة في مجال الطاقة نحو بناء سياسات مشتركة على مستوى المنطقة. فهما يتشاركان النفوذ في دول آسيا الوسطى، ويمكن أن يعززا روابطهما مع هذه الدول، من أجل تعزيز اقتصاديهما، والتنسيق معاً للتضييق على حركات التطرف الإرهابية. وربما شكلت أنقرة بديلاً من طهران إذا جازفت هذه وذهبت بعيداً في علاقاتها مع واشنطن في ضوء اتفاق نووي مرض يرفع عنها سيف العقوبات، ويفتح الباب واسعاً أمام الشركات الأميركية والغربية عموماً. علماً أن أوساطاً دولية تشير إلى تفهم في أوساط الرئيس حسن روحاني وفريقه لتسوية تأخذ في الاعتبار شيئاً من مضمون «جنيف 1» بما يرضي المعارضة. لكن الجناح المتشدد لا يزال يرفض تقديم أي تنازل في الساحة السورية، بل يبحث عن سبل الرد على السعودية انطلاقاً من اليمن. والأوساط نفسها لاحظت أن بعض العرب من «أصدقاء سورية» باتوا أكثر اقتناعاً بالبحث عن تسوية تطمئن الأقلية العلوية وتحافظ على المؤسسة العسكرية بعد إعادة هيكلتها وإبعاد العناصر القيادية التي تلوثت أيديها بالدماء. وهناك من يتداول صيغة مشابهة لصيغة الحكم في العراق. أي أن تبقى الرئاسة للعلويين من باب طمأنتهم، على أن تنتقل الصلاحيات التنفيذية الرئيسية إلى رئيس الوزراء السني. مثل هذا الحل يحمل ضمانات لروسيا ببقاء قاعدتها العسكرية في طرطوس. مثلما يحفظ أيضاً شيئاً من النفوذ لإيران يبقيها على تواصل مع الساحة اللبنانية. لكن المبالغة بالتفاؤل تصطدم بكم هائل من العراقيل. يكفي أن بعض الدوائر الغربية ترتاب من تحرك الكرملين. وتخشى من سعيه إلى عرقلة الاتفاق النووي بالإفراج عن صفقة صواريخ «اس 330» لإيران لدفعها نحو التشدد وكسر الحصار. ويسعى إلى تحويل الشرق الأوسط عنصراً أساسياً في الحرب الباردة مع الولايات المتحدة والغرب عموماً. فهل يكون البديل من فشل التسويات واستحالة التلاقي بين المكونات الوطنية في العراق واليمن وسورية الذهاب بعيداً في رسم حدود جديدة بين هذه المكونات لا تمس الحدود الدولية التي خطها سايكس وبيكو؟ ألا تقدم صيغة الدولة الفيديرالية أو الاتحادية ضمانات أكثر صدقية للنفوذين الروسي والإيراني؟ الأجوبة مع نهاية الشهر المقبل ومصير تحرك المبعوثين الدوليين في اليمن وسورية! *نقلاً عن "الحياة"