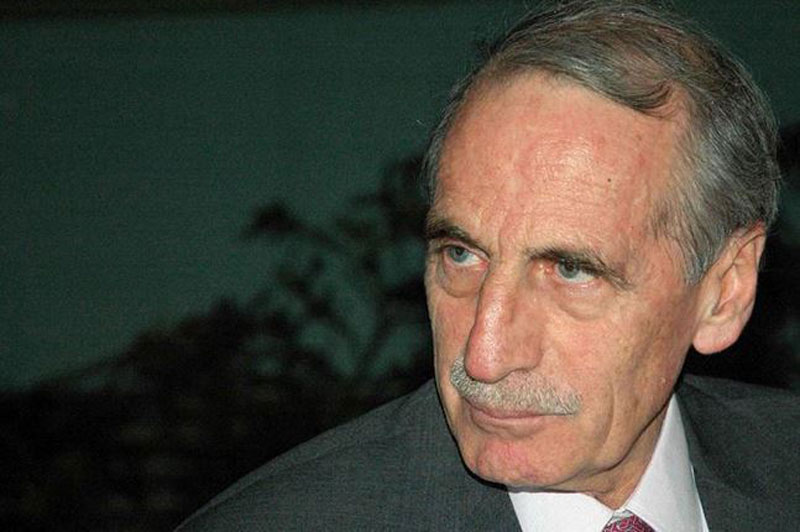«سورية الجديدة»

مددت الأمم المتحدة فشل مندوبها إلى سورية ستيفان دي ميستورا، فالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن هذا الأسبوع هو، فضلاً عن كونه بياناً، لا يحمل في طياته أي آلية تمكن المندوب الدولي من تنفيذ خطة طرح مثلها سابقاً لتطبيقها في حلب ولم تر النور، وبقيت العاصمة الاقتصادية السورية عرضة للحروب والانتهاكات، لا بل وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة لزيادة دعم المسلحين وتعطيل أي حل فيها، مهدداً مرة بإقامة منطقة عازلة، بناء على «اتفاق مع أميركا»، وأخرى بإرسال جيشه عبر الحدود لضرب الأكراد. البيان الرئاسي الذي صاغته فرنسا واعتبرت صدوره انتصاراً ديبلوماسياً لها لأنه أعاد إحياء مقترحات جنيف1 حين كانت باريس أحد رعاته الأقوياء، حظي بموافقة روسية على صياغة ملتبسة لمسألة «الحكومة الانتقالية»، من دون الأسد أو في حضوره، باستبدال هذه العبارة بأخرى تدعو إلى إقامة «هيئة انتقالية جامعة لديها الصلاحيات التنفيذية كافة، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية». ويدعو البيان أيضاً إلى تشكيل أربع فرق عمل تأخذ على عاتقها تحقيق الآتي: الأمن والحماية. مكافحة الإرهاب. البحث في القضايا السياسية والقانونية. وإعادة الإعمار. وترك لدي ميستورا تحديد المشاركين في هذه الفرق من المعارضة والنظام، من دون أن يقترح آلية لعملها أو لدعمها أو الإشراف عليها. ولم يحدد مرجعيتها حين يختلف أعضاؤها أو تتعرض للانهيار. الأهم من ذلك أن البيان لم يتطرق إلى الرعاة الذين يمكن أن يعرقلوا عمل هذه اللجان، أو يساعدوها، فالخلافات واسعة بين الدول الإقليمية الكبرى المعنية، حرباً أو سلماً، في سورية. وكان لها، وما زال، تأثير كبير في هذا البلد المنكوب، فضلاً عن الصقور الدوليين وحساباتهم ومصالحهم. في الإقليم هناك أربع دول يمكنها أن تغطي عمل اللجان المقترحة وتتدخل حين تعترض عملها صعوبات هي، مصر وتركيا والسعودية وإيران. لكن بينها خلافات مستحكمة على كل شيء. بين تركيا ومصر وصلت العلاقات إلى حدود القطيعة لأن أردوغان اعتبر وصول السيسي إلى الرئاسة انقلاباً على حلفائه «الإخوان المسلمين»، وما زال مصراً على ذلك. أما الخلافات السعودية - الإيرانية فلا تقتصر على الموقف من النظام السوري، بل تتعداه إلى الموقف من اليمن ولبنان والخليج والعراق، كي لا نذكر أفغانستان وباكستان وباقي الدول الإسلامية، ولكل من الرياض وطهران مصالح وأنصار يخوضون صراعات وحروباً بالوكالة عنها. دولياً، صحيح أن هناك نوعاً من التقارب بين روسيا والولايات المتحدة في ما يتعلق بالمسألة السورية، ما أتاح لمجلس الأمن إصدار بيانه بالإجماع، لكن الصحيح أيضاً أن الطرفين ما زالا مختلفين على «سورية الجديدة» ونظام الحكم فيها. واشنطن سعت، وتسعى، إلى إيجاد حليف عسكري من «المقاومة المعتدلة» يشكل ضمانة لها داخل المؤسسة العسكرية حين تبدأ المساومات، وهي تدرب عناصر هذه القوة في تركيا والأردن، وتدعمها بالسلاح والمال في انتظار اللحظة المناسبة لإعطائها الأوامر بإثبات وجودها على الأرض. ولكم أن تتخيلوا عقيدة هذه القوة ومدى علاقتها بسورية الماضي أو المستقبل. أما روسيا (دع فرنسا وبريطانيا جانباً) فمتمسكة ببقاء ما بقي من النظام لضمان مصالحها في المشرق، معتمدة على علاقاتها التاريخية بدمشق، من دون أن تقطع صلاتها بالمعارضة المسلحة وغير المسلحة، عدا «داعش» و»النصرة»، وتسعى إلى إيجاد صيغة وسط يتوافق عليها الطرفان، داعية إلى ترك السوريين يقررون مصيرهم ومصير نظامهم الجديد، من دون إملاءات. ويبدو هذا الطرح خيالياً، إلى حد بعيد، فالمعارضة غير موحدة، لكل فصيل منها، وعددها بالعشرات، عرابه وراعيه ومموله الذي يسعى إلى الحصول على حصته من التركة «السائبة»، على ما يعتقد. باختصار شديد، يبدو بيان مجلس الأمن تجديداً لفشل دي ميستورا في انتظار أن يدمر ما بقي من سورية القديمة بتراثها ومعمارها وناسها. أما سورية الجديدة، حين تنهض، فستكون أشبه بشركة متعددة الجنسية، لكل دولة فيها حصة. صحيفة الحياة