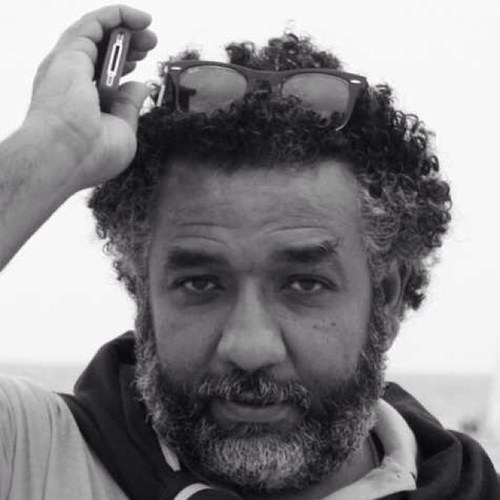عولمة الرعب

العرب - اذا كنا قد فهمنا رسالة باراك أوباما في خطابه الأخير حول حالة الاتحاد، وهو الخطاب الذي جاء هادئا عقلانيا بعيدا كل البعد عن تلك الحالة الانفعالية التي سبق أن استبدت بجورج والكر بوش وفريق عمله إبان حربهم على الإرهاب، وإذا كنا قد استوعبنا مقاصد العديد من المفكرين الغربيين في مقارباتهم لمخاطر الظاهرة الإرهابية (أوليفييه روا، مارسيل غوشيه إلخ)، فالملاحظ أن ثمة ملامح وعي كوني بضرورة تفادي الوقوع في فخ الخوف. فالخوف هو الفخ الكبير الذي يبتغيه الإرهابيون في آخر المطاف.
لذلك ليس غريبا ولا مستغربا أن تحرص معظم الجماعات الإرهابية على تصوير وإخراج جرائمها البشعة بأسلوب جعلها تتفوّق في آخر الحساب على سينما الرّعب وتسرق منها سحرها، وجعل أفلام ويس كرايفن وهيتشكوك تبدو كأنها مجرّد تسلية سهلة. عموما ثمة فرق شاسع بين رعب السينما ورعب الواقع: في أفلام الرّعب فإننا نذهب بأنفسنا ونؤدي ثمن التذكرة مقابل لحظات من الإحساس المبهج بالخوف طالما أننا نعرف أن الأهوال التي نراها في الفيلم لا تحدث على وجه الحقيقة، فلا الدماء حقيقية، ولا الأعضاء المبتورة حقيقية. والمؤكد أن إدراكنا لهذه المعطيات الفنية هو الشرط الأساس لتحقيق متعة الفرجة على أهوال العنف. بهذا النحو نستطيع أن نتحمل مشاهد الرّعب حتى نهاية الفيلم. وما إن يُسدل الستار وتشتعل الأضواء حتى يكون الشعور بالرّعب قد تلاشى وزال، تماما كما أننا نتعاطف في السينما مع السفاح الهارب من العدالة فقط لأننا ندرك بأن وقوعه في يد العدالة يعني نهاية الفرجة، لكننا ما إن نغادر قاعة السينما حتى نتجنب كل الأمور المرعبة ولا نبدي أي قدر من التعاطف مع المجرمين والسفاحين.
إن الشرط الأساس لتحقق الفرجة هو معرفتنا بأن السينما ليست الواقع، إذ أننا لا نقبل التورط في أجواء الرعب والتواطؤ مع السفاحين إلا لأننا ندرك في صميم أنفسنا بأن الدماء التي نراها في الفيلم مجرّد طلاء أحمر، وأن الرؤوس المقطوعة مجرّد دمى ورقية أو خدعة بصرية.
غير أن الأشرطة والفيديوهات التي تصوّر عن قرب، مشاهد الموت بالذبح أو الحرق أو الخنق أو الصعق، وهذا لم يكن متاحا بنحو واسع قبل منتديات التواصل الاجتماعي، قد أفرغت سينما الرعب من وهجها وأزالت عنها سحرها. لقد رفعت السقف إلى الحد الذي لم تعد السينما قادرة على بلوغه. على الأقل، سيحتاج الأمر إلى انقلاب حاسم في تقنيات إنتاج الرعب السينمائي.
أن يفجّر شخص نفسه وسط الزحام محوّلا الناس إلى أشلاء متناثرة، وأن يوضع أسرى أحياء داخل قفص حديدي فتهبط بهم الرافعة ببطء شديد نحو سطح البحيرة ثم إلى القعر بعد تثبيت كاميرات تحت الماء، وأن يقيم الابن الحد على أمه التي أنجبته وأرضعته أمام الملأ، وأن يُطلب من طفل في الثانية عشرة من عمره أن يطلق الرصاص على سجين أو يقطع رقبته ليشفي غليله، فهذا يعني أننا دخلنا إلى مرحلة “إدارة التوحش”. الإحالة هنا إلى كتاب لم نحمله وقت ظهوره على محمل الجد، كتاب أصدرته شخصية افتراضية تسمّى بأبي بكر ناجي، قبل أزيد من عشر سنوات. لا شك أن بعض الكلمات قنابل موقوتة في انتظار ساعة الانفجار. وربما هذه هي حالة كتاب “إدارة التوحش” والذي حاول توجيه القوى التكفيرية نحو استراتيجية عولمة الرعب.
ليس خافيا أن الخوف حالة انفعالية قد تقود إلى تجميد العقل، وقد تدفع إلى الارتباك في اتخاذ المواقف، أو اتخاذ مواقف غير محسوبة ومتهورة. وهذا أعزّ ما يطلبه صنّاع الرعب في الأخير. الخوف هو الفخ الذي وقع فيه جورج والكر بوش عندما أجاب عن اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بتدمير العراق. وهو الخطأ الذي وفر بيئة ملائمة لتغول التطرف الجهادي. إذا كنا قد فهمنا الخطاب السياسي والفكري الراهن في مقاربة موضوع الإرهاب، فالملاحظ أن ثمة إصرارا على مكافحة الإرهاب بجدية وفي كافة الأصعدة، لكن دون الوقوع في فخ الخوف.
هناك فخ ثان، هو الآخر من طبيعة انفعالية، الحقد. لسنا نشك قيد أنملة في أن مبادلة دعاة الحقد بحقد مضاد تعني الوقوع في فخ تعميم الحقد. وهذا أيضا أعز ما يطلبه الإرهابيون. لكن، هل يمكننا أن نقاتل الإرهابيين دون أن نواجههم بالحقد والكراهية؟ هذا ليس ممكنا وحسب لكنه ضروري أيضا. إذا كان الحقد أعمى كما يقال فإن المعارك الناجعة لا تحتاج إلى عميان. بل حتى أثناء الحروب الأكثر شراسة، فإن التحكم في الانفعالات والغرائز البدائية يعدّ شرطا ضروريا لأجل تحقيق الانتصار. يصدق هذا الأمر حتى عندما نضطر إلى مواجهة الهمجية، بل هنا يصدق الأمر أكثر. لذلك لاحظنا كيف يحاول الخطاب الثقافي الراهن في مقاربة خطر الإرهاب تفادي الوقوع في فخ الحقد. “لن أمنحكم كراهيتي”، هكذا أجاب الصحفي الفرنسي أنطوان ليريس في رسالة نشرها بعد أن فقد زوجته (وأم ابنه الصغير) في اعتداءات باريس الأخيرة.
في المقابل، إذا كنا قد استطعنا فهم مضامين أهم الكتب المرجعية للإرهاب الجهادي (الفريضة الغائبة لعبدالسلام فرج، فرسان تحت راية النبي لأيمن الظواهري، إدارة التوحش لأبي بكر ناجي)، فإن الغاية القصوى للعمل الإرهابي هي إلقاء الرعب في قلب “العدو”، ونشر ثقافة الحقد، بمعنى تعميم الأحقاد كحالة انفعالية جامحة في مجال العلاقات بين الأفراد والدول والمجتمعات والطوائف. ولأن “العدو” اليوم هو كل من لا يقبل الاحتكام إلى “شرع الله”، أي تقريبا العالم بأكمله (الصليبيون، الماسونيون، المجوس، اليساريون، الليبراليون) فإن المطلوب هو إلقاء الرعب في قلوب الناس أجمعين، أي عولمة الرعب. وأيضا لأن الولاء لا يكون للكفرة والمرتدّين والمعطلة والمبتدعة والقاعدين عن الجهاد، فإن الحالة الطبيعية ستكون هي حالة الحقد على الجميع.
ولأن العالم بأكمله قد دخل في منظور الإسلام السياسي إلى “جاهلية القرن العشرين”، بل أمسى القرن الحادي والعشرين أكثر رسوخا في الجاهلية وفق الرؤية التكفيرية الأكثر تشددا، إذ لم يعد هناك من مجال لدار الحرب مقابل دار الإسلام، وإنما أصبح العالم كله دار حرب، لكل ذلك تبدو عولمة الرعب منسجمة مع كون العالم بأسره أصبح دارا للحرب.
في كتابه “إدارة التوحش” قدم أبوبكر ناجي صورة واضحة عن سياسة الرّعب كاختيار استراتيجي في إدارة الفوضى داخل المناطق التي ستنهار فيها أو تنسحب منها الدولة. والأكثر إثارة في الموضوع أن هذا الكلام قيل قبل بدء ما سمّي بالربيع العربي بسنوات. في هذا الكتاب، وفي الكتب التي على شاكلته، يحمل الرّعب هدفا مزدوجا: كسر نفسية الأعداء باعتبار أنّ الخوف يشلّ إرادتهم وعزيمتهم، واستقطاب مجندين جدد إلى مركز الرعب. إن الأهداف مسطرة ومعلنة سلفا، غير أن “حراس المعبد” يفضلون دائما البحث عن جذور المؤامرة خارج الذات.
الآن، ثمة مسعى حثيث نحو عولمة الرّعب، وثمة في المقابل مسعى مضاد نحو مقاومة الرّعب المعولم بشتّى السبل مع تجنّب الوقوع في فخ الخوف. فالخوف فخ كبير قاد إلى تشويه الشخصية الثقافية للعديد من الشعوب التي عانت من ويلات الإرهاب. ولأجل تجنب هذا الفخ يجب الحفاظ على إيقاع الحياة، بل يجب أن يرتفع إيقاع الحياة أكثر فأكثر، يجب أن تنتصر إرادة الحياة على غرائز الموت في كل التفاصيل اليومية، يجب العمل على تنمية الطاقة الحيوية لدى أكبر قدر ممكن من الأفراد. بكل تأكيد، وبمعزل عن الأوهام الصغرى التي يحتاجها صغار النفوس، ندرك بأن الحياة قصيرة الأمد وأن الموت هو الدوام، ندرك بأن الوجود عرضي وأن الفناء هو المقام، نشعر كأننا هنا بلا سبب، أو لسر أو لغز لا يعنينا، ندرك بأننا نحمل في أحشائنا وجعا يولد معنا، وقد يدفعنا إلى اليأس والقنوط..
هنا قد نفكر عميقا، قد تغمرنا مشاعر غامضة، قد نغرق في تأمل طويل، وقد نصل إلى خلاصات مؤكدة أو مؤقتة، وربما لا نصل إلى أي خلاصات على الإطلاق، وقد نهيم بحثا عن بلسم لجرح الكينونة فنلوذ بأنفسنا إلى أحوال الحب أو رحاب الموسيقى أو أحضان الدين أو حافة الانتحار، وقد نستعجل الآخرة، فلا بأس بهذا كله أو بعضه، لكن هناك شيء واحد لا يمكننا تبريره: كيفما كانت نظرتنا للحياة لا يمكننا أن نمنع الآخرين من الحياة.