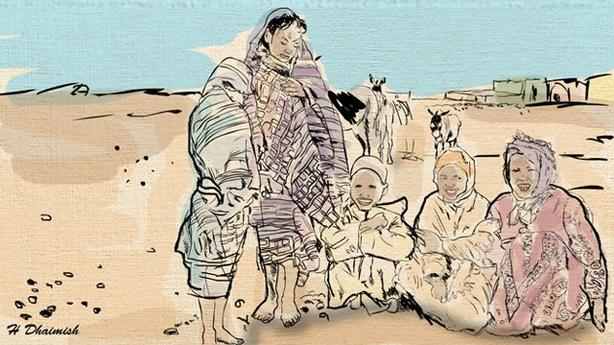ماذا عن فيدرالية مصرية ـ ليبية ـ تونسية؟

من الواضح أن الإرهاب أصبح عابراً للحدود والقوميات. وهو ما ينطوى عليه حتى اسم «داعش»، أى الدولة الإسلامية فى العِراق والشام. ولم يقتصر الأمر على الاسم، ولكن أيضاً على الفضاء الذى يتحرك فيه تنظيم داعش. فرغم أن بداياته الجنينية كانت فى محافظة الموصل بشمال العِراق، وكان مؤسّسوه هم فلول جيش صدام حسين الذى فضه أول حاكم أمريكى للعِراق، وهو بول بريمر (Paul Bremar)، اعتقاداً منه أن فى ذلك قضاء تاما على المؤسسة العسكرية العِراقية، التى مثلت صداعاً دائماً للولايات المتحدة، بعد حرب الخليج. ولم يدر بخُلد بريمر، أو مُساعديه، أن هناك ظاهرة يعرفها عُظماء الاجتماع جيداً، مؤداها أن لكل فعل إنسانى وظائف ظاهرة وعاجلة، وأخرى باطنة ومؤجلة. من ذلك أن ضُباط جيش صدام، وخاصة تحت سن الثلاثين من أعمارهم كانوا لايزالون فى ريعان الشباب، وذوى لياقة بدنية عالية، وذوى كفاءة مهنية لا يُستهان بها. ولأن صدام حسين كان يُحابى أبناء الطائفة السُنّية، على حساب الطوائف الأخرى التى يمتلئ بها المجتمع العِراقى ـ مثل الشيعة، والأكراد، والتركمان. فكان معظم شباب الضُباط من أبناء الطائفة السُنّية ينحدرون من أصول عربية، فما كان من هؤلاء الأخيرين إلا تنظيم أنفسهم سراً، واستعداداً لأول فُرصة للقفز على السُلطة. ولأنهم كانوا قد تربوا سياسياً على العقيدة البعثية القومية الوحدوية، ولكنهم أدركوا فى مُقتبل القرن الجديد، الحادى والعشرين، أن الدعوة الإسلامية هى الأكثر جاذبية للأجيال الجديدة، فقد مزجوا الدعويين القومية والإسلامية. فما هو دليلنا على هذا الاستنتاج؟ الدليل الأول، هو أنه لو كانت الدعوة إسلامية فقط، لشملت كل بلاد المسلمين، وأكبرها إندونيسيا وباكستان وإيران، ولم تكن لتقتصر على بلاد العِراق والشام. القرينة الثانية لنفس الاستنتاج، هى أن حزب البعث لم يحكم إلا فى العِراق والشام (سوريا)، وأن وصوله للسُلطة فى البلدين فى ستينيات القرن الماضى كان بالأسلوب الانقلابى الدموى، وهو نفس الأسلوب الذى لجأت إليه ومازالت داعش تُمارسه. القرينة الثالثة، هى أن داعش تمتد وتتوسع حيثما تكون هناك حالة فوضى، أو فراغ، أو نظام سياسى هش. ولذلك قفزت داعش من العِراق والشام، إلى ليبيا، على بُعد ألف ميل تقريباً، بينما كان الأقرب لها جُغرافياً الأردن والسعودية وفلسطين ومصر. ولكن إدراكها أن السُلطة فى الأردن والسعودية وفى مصر، قوية صلبة، بينما هى ليست كذلك فى ليبيا، التى ما زالت فى حالة قلاقل وسيولة ما بعد ثورة فبراير 2011، فضلاً عن اتساع مساحتها (أكثر من 2.0 مليون كيلو متر مربع). وكان تجاوز داعش لمصر والأردن والسعودية، مؤقتاً، لذلك سرعان ما أصبح لها موطئ قدم فى ليبيا، فإنها بدأت على الفور من خلال أنصارها باختبار صلابة نظام السيسى فى مصر، ورد فعله لاستفزازات إعدام مصريين يعملون فى ليبيا. لقد كانت استجابة نظام الرئيس السيسى لاختطاف ولإعدام 21 مصريا، بشن هجمات جوية على قواعد داعش فى ليبيا، لا بد أن تكون قد أقنعت الجميع، بأنه يأخذ حياة المصريين وكرامتهم مأخذاً جاداً إلى آخر مدى. وكان رد فعل السُلطة الليبية الوحيدة المُنتخبة فى طبرق، هو تأييد الضربة الجوية المصرية. بل يُقال إن القوات الليبية المُنشقة على سُلطة الإسلاميين فى طرابلس، قد شاركت فى تلك الضربة الجوية. كما عبّر مواطنون ليبيون كثيرون عن ارتياحهم لتأديب تلك العناصر الداعشية الدخيلة على وطنهم. ولكن الحصافة السياسية، والحكمة الإقليمية تستدعيان استراتيجية أبعد مدى من مُجرد ردود الفعل السريعة للإرهاب داخل نفس البلد، أو عبر الحدود. وهذا ما جرّبته أوروبا، حينما كانت تتعرض دورياً لخلافات أو صراعات دورية على حدودها، أو عبر تلك الحدود. وهو ما دفع كلا من ألمانيا وفرنسا أن تُبادر فى خمسينيات القرن الماضى بسوق مشتركة، سرعان ما تطورت تدريجياً إلى الاتحاد الأوروبى. وهو ما ينبغى أن يحفز مصر وجارتيها إلى الغرب، ليبيا وتونس، إلى ترتيبات أمنية، تدعمها تنسيقات اقتصادية لانتقال العمالة والتجارة عبر الحدود، أملاً فى كونفيدرالية تجمع البُلدان العربية الثلاثة، فإذا نجحت واستقرت التجربة، فإنها ستُجذب بالقطع، دول جوار أخرى مثل الجزائر والسودان. وهو ما قد يتطور بالفعل إلى ما يُشبه الاتحاد الأوروبى. ونعتقد أن الاتحاد الأوروبى نفسه لن يُعارض، بل أغلب الظن أنه سيُرحب بوجود كيان إقليمى قوى فى جنوب المتوسط، يحفظ الاستقرار فى فنائه الخلفى، ويضبط حركة تهريب المُخدرات والهجرة غير الشرعية. وهكذا، يمكن القول إنه رُبّ ضارة نافعة. فليكن الإرهاب عبر الحدود، حافزاً للتنسيق، ثم التكامل، ثم الاتحاد بين بُلدان الشاطئ الجنوبى للمتوسط. وليكن ذلك إحياء للحلم العربى، الذى داعب خيال أربعة أجيال عربية مُتعاقبة خلال القرن الماضى، من أجل توحيد أقطار الأمة الواحدة، ذات الرسالة الخالدة. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد وعلى الله قصد السبيل *نقلاً عن "المصري اليوم"