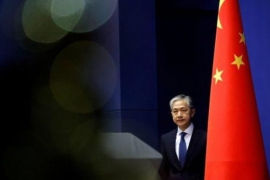زيارة أوباما:تكريس التحالف مع الخليج والمصالحة مع إيران

الحياة - لن يحمل الرئيس باراك أوباما الى القمة الخليجية في الرياض الأسبوع المقبل، سياسة أميركية جديدة تتنافى مع عقيدته التي نفذها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ولن يُلزِم من يخلفه في البيت الأبيض باستراتيجية المفاجأة. ما يتأبطه الرئيس المغادر منصبه بعد تسعة أشهر، يدور في فلك إعادة تشييد الترابط الاستراتيجي الأميركي – الخليجي ورفع مستوى آليات تعزيزه في إطار الرؤية المستندة الى تنويع العلاقات الاستراتيجية الأميركية مع كبار اللاعبين في المنطقة في إطار موازين القوى الإقليمية.
رأي الرئيس باراك أوباما الثابت هو أنه أحسن الأداء في قلب صفحة العداء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رأيه أن هذا الإنجاز يصب في المصلحة القومية الأميركية وكذلك في مصلحة الشرق الأوسط. ما لا يريده هو إنهاء ولايته تحت الانطباع بأنه أفسد العلاقات الأميركية مع الحلفاء التقليديين في دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات السعودية، انحناءً أمام الأولوية الإيرانية. ولذلك يود ترميم العلاقة الأميركية – الخليجية إنما بلا تراجع ولا اعتذار. يريد إحياء العلاقة الأميركية – المصرية الاستراتيجية، إنما من دون القفز على ممارسات الحكومة المصرية ضد المجتمع المدني وحرية الرأي والحق بالاختلاف في الرأي السياسي وضد الإسلاميين. وقد يريد، وفق ما يتسرب من معلومات، أن يأخذ بالرأي الداعي الى إصدار قرار عن مجلس الأمن يتبنى أسس التوافق التي توصلت إليها المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية من دون أن تثمر اتفاقاً. هذه العناوين مفيدة للصفحة الأخيرة في علاقة باراك أوباما مع الشرق الأوسط، وهي تتقاطع مع تحرك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، لا سيما في زيارتيه المهمتين الى القاهرة وإسطنبول.
في العاصمة المصرية، كرّست زيارة الملك سلمان رابطاً خليجياً – مصرياً يقوّي الوزن المصري بالثقل الخليجي في إطار موازين القوى الإقليمية التي تضم إيران وتركيا وإسرائيل. لهذا المحور وزن كبير، أولاً، في قرارات جامعة الدول العربية وارتــباطها بالبــعد الدولي وليـــس فقط بالبعدين العربي والإقليمي. له انعكاس اقتصادي وسياسي على مصر، إذ إن هناك ائتلافاً خليجياً – مصرياً في الاقتصاد والسياسة. أحد أبعاد هذا الروابط يصب في العلاقة الأميركية – المصرية وكذلك في العلاقة الأوروبية – المصرية، علماً أن هذه العلاقات ليست في حالة جيدة بسبب السياسات المصرية التي يعتبرها الغرب تعسفية ومفرطة في سجن الرأي المخالف ومصادرة الرأي الحر وملاحقة المنظمات غير الحكومية.
أحد الخليجيين المخضرمين اعتبر أن الديبلوماسية المصرية «لم تعد أيديولوجية اشتراكية للزعامة الإقليمية وإنما أصبحت أقرب الى السياسة الخليجية الرافضة للأيديولوجيات والحكومات الراديكالية». إنما هذا لا يخفي الاختلافات في السياسات الخليجية – المصرية في شأن تركيا، علماً أن السعودية تصوغ علاقات استراتيجية مع تركيا بينما مصر تعتبر أنقرة معادية للحكم في القاهرة وتريد إحياء حكم «الإخوان المسلمين». الاختلاف يتناول السياسات نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث مصر لا توافق السعودية والإمارات والبحرين، مثلاً، على تصنيف الخطر الإيراني واعتباره وجودياً. مصر أيضاً تختلف مع الدول الخليجية في سياساتها نحو سورية، إذ إن القاهرة لا تتبنى سياسة محورية ترحيل بشار الأسد عن السلطة ولا تضع ثقل اهتمامها في المسألة السورية. تضعه في المسألة الليبية حيث الاهتمام الخليجي أقل من المصري. أما في المسألة اليمنية، فإن سوء الفهم وسوء الحسابات أضعفا الثقة المتبادلة، وما زالا.
الرسالة الخليجية الى مصر في شأن العلاقات مع الولايات المتحدة هي أن العلاقات الأميركية – الخليجية باقية ودائمة وستتعزز وتزداد ترابطاً، وأن مصر ليست البديل عن العلاقة الاستراتيجية الأميركية – الخليجية. السياسات الخليجية – الأميركية تتلاقى في اعتبار مصر شريكاً أساسياً في التصدي للإرهاب والتطرف. دول الخليج قد تكون أكثر تفهماً للإجراءات الأمنية المصرية الصارمة حتى ولو اختلفت مع بعضها، لكن الولايات المتحدة وكذلك الدول الأوروبية تنتقد بشدة القبضة الحديد للجيش والشرطة في إدارة البلاد بلا انفتاح ولا شفافية. هذه الدول ترى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي غير قادر على اتخاذ القرار المؤثر في تغيير جذري في مصر نحو الانفتاح الاقتصادي والسياسي، ولذلك إنها غير مستعدة للاستثمار في مصر. لكن العلاقة المصرية – الإسرائيلية هي التي ترطب أجواء الغضب الأميركي لأنها، وفق مصدر أميركي وثيق الاطلاع، أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى» وأحد الأسباب هو التعاون ضد «داعش» الإرهابي وضد «حماس» - الإخوان المسلمين.
أما في ما يخص العلاقات المصرية – التركية، فلا مؤشر الى تمكّن أي كان من إصلاحها في هذا المنعطف. فلا الأتراك يريدون التفاهم مع القيادة المصرية، ولا المصريون يريدون المصالحة مع القيادة التركية.
زيارة العاهل السعودي الى عاصمتي العدوّين أتت بناءً على اقتناع مسبق بأن لا مجال لإزالة الجليد عن العلاقة المصرية – التركية، وأن الأفضل فصل التوجه السعودي نحو مصر عن التوجه السعودي نحو تركيا لغايتين مختلفتين. ففي رأي الرياض، إن أنقرة مهمة جداً في تأثيرها في سورية وإيران، ومن الضروري الاستفادة من هذا التأثير. رأيها أن تركيا رئيسة في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب فيما دور مصر ثانوي.
فالثقل الخليجي – التركي في القيادة الإسلامية للتحالف الإسلامي يشكل محوراً يختلف عن الثقل الخليجي – المصري في موازين القوى الإقليمية، وفق التفكير في منطقة الخليج. ثم إن تركيا قادرة على لعب دور مع إيران أعمق وأوسع من الدور الذي يمكن مصر أن تلعبه مع طهران. إذاً، هناك محوران منفصلان، وفق التفكير الخليجي. الإدارة الأميركية تبدو مرتاحة لهذا التفكير، تدعم التأثير في مصر والتعاون مع تركيا ضمن التحالف العسكري الإسلامي في الحرب على «داعش» وفي إطار إمكانية التأثير في العلاقة الخليجية – الإيرانية.
القمة التشاورية بين الرئيس الأميركي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخل، على الأرجح، في هذه التفاصيل وستركز على رسالة إصلاح العلاقة الأميركية – الخليجية على صعيدين: صعيد التوتر وانحسار الثقة بالولايات المتحدة إثر التودد الأميركي لطهران بإعفاء تام لها عن سياساتها الإقليمية المتمثلة بدورها العسكري في سورية مباشرة وعبر «حزب الله»، بالدرجة الأولى. وصعيد العلاقات الأمنية الأميركية – الخليجية.
في ما يخص العلاقات الثنائية الأمنية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، إن التشاور والتعاون الاستراتيجيين سيتصدران أولويات إصلاح العلاقة – ولن يكون الأمر صعباً. ذلك أن الرأي الأميركي هو أن لا تناقض بين التودد الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطي صفحة العداء معها وبين علاقات استراتيجية مع الدول العربية الخليجية على رغم إطاحة عقيدة أوباما بعقيدة الرئيس الأسبق جيمي كارتر التي ضمنت التحالف الأمني الاستراتيجي مع الدول الخليجية العربية، وبما أن الدول الخليجية جاهزة لتقبل هذه التطمينات، لن يكون ترميم العلاقة صعباً لا سيما أن العلاقة الأمنية تنطوي على عنصر شراء السلاح.
أما في ما يخص أنماط الإعفاء الأميركي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من بُعد العبث بالاستقرار الإقليمي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على إيضاح رفضها مباركة سياسة الإعفاء من المحاسبة واحتفاظها بحق الاختلاف مع واشنطن حفاظاً على مصالحها الحيوية. ستؤكد هذه الدول مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وستشير الى إقرار طهران بأنها توفد محاربيها الى سورية كمثل ساطع على الاختلاف مع واشنطن، التي اختارت غض النظر عن هذه التجاوزات. ســتقول للرئيس الأميركي أن تركته التاريخية المتمثلة في الصفقة النووية مع إيران وطي صفحة العداء معها ليست صكاً شرعياً مُلزماً لها إذا كان الهدف منها مباركة غايات الهيمنة الإيرانية على الدول العربية.
الاختلاف عميق. فإدارة أوباما تؤمن بأن الأوتوقراطية العربية هي مصدر البلاء ويجب على الولايات المتحدة التصدي لحكم «الرجال الأقوياء» في الساحة العربية، وفق تعبير السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سمانتا باور، إنما هذه الإدارة ترفض قطعاً انتقاد الثيوقراطية الإيرانية وتسلط الرجال الأقوياء في الساحة الإيرانية. إدارة أوباما عكفت على محاسبة الرجال الأقوياء في الأوتوقراطية العربية وإسقاطهم من السلطة، وعقدت العزم في الوقت ذاته على إعفاء الرجال الأقوياء في الثيوقراطية الإيرانية من المحاسبة. الاختلاف عميق.
فسحة التفاهم في هذا المجال ليست واسعة لا سيما أن ادارة أوباما دخلت البيت الأبيض متأبطة القيم العليا وهي تغادر البيت الأبيض وسجلّها ملطّخ بسياسة تعمّد غض النظر عن القيم وعن الممارسات الفظيعة في المأساة السورية. في هذا الأمر، لا مجال لإصلاح ما أفسده الدهر. لم يعد يحق للولايات المتحدة أن تزعم أنها في مرتبة أعلى من القيم الأخلاقية بسبب السياسة الأميركية نحو سورية التي نفذها الرئيس باراك أوباما بناءً على استيعابه للأولويات الأميركية الشعبية القائمة: لا دور لنا في حروب الآخرين ولا شأن لنا في مجازر المدنيين في الأماكن البعيدة.
لعل أوباما يتمنى أن يغادر البيت الأبيض بتركة غير هذه وبتركة لا تسجنه حصراً في الوقوع في غرام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رغم تجاوزاتها وسياساتها التخريبية والتعطيلية والتحالفية مع بشار الأسد و «حزب الله» في سورية وفي لبنان.
هناك من يريد له أن يسعى وراء حدث مهم في الملف الفلسطيني – الإسرائيلي الذي تأبطه لدى دخوله البيت الأبيض متوعداً باختراق تاريخي ومعتبراً حل النزاع في صميم المصلحة القومية الأميركية. وعليه، يوجد تفكير في أوساط الإدارة الأميركية وحولها يصب في خانة محاولة استصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع يصون مبدأ حل الدولتين من خلال تدوين المبادئ الأساسية لهذا الحل.
الحديث يدور عن تطوير للقرار الشهير الذي صدر في أعقاب الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1967، الذي حمل الرقم 242 ليشمل فلسطين وليكون أساساً للمفاوضات اللاحقة إنما شرط ألا ينطوي على آلية إلزام عبر العقوبات ولا على إطار زمني للتنفيذ.
القرار 242 خدم كأساس للمفاوضات المصرية – الإسرائيلية ومعاهدة السلام بينهما بعد مرور سنوات عدة، وخدم أيضاً كأساس للسلام بين الأردن وإسرائيل بعد مرور سنوات عديدة. الفكرة هي إرساء هذا القرار مطوّراً ليشمل فلسطين وليكون أساس الاتفاقية الفلسطينية – الإسرائيلية عندما يحين الأوان بعد سنة أو سنوات عديدة.
هكذا، في رأي مسوّقي مثل هذا القرار، يمكن الرئيس الأميركي الآتي أن يتحرك على أساس مرجعية واضحة قائمة على دولة فلسطينية ودولة يهودية. مرجعية تتمتع بإجماع دولي عبر قرار لمجلس الأمن يكون سابقة.
الأرجح أن يعارض الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني مثل هذا القرار لأن على كليهما التنازل عن شيء ما. ولعل الرئيس باراك أوباما يفضل ألاّ ينهي ولايته بهزيمة، فلا يوافق ولا يسعى. إنما لعله يجد في هذه الأفكار وسيلة لإنهاء ولايته في البيت الأبيض بقرار يتوّج رغبته وجهود وزير خارجيته جون كيري، ويمكنه من القول انه نفذ ما تعهد به في نهاية المطاف.
كل رئيس أميركي يهرول في نهاية ولايته الى جديد في المسألة الفلسطينية – الإسرائيلية. الرئيس باراك أوباما يفضل الظهور بأنه يتألق في خطاه المدروسة الباردة والبطيئة بكل حذر. وهذا ما سيفعله في زيارته التشاورية مع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية وما سيليها من قرارات يتخذها وهو يحزم حقائبه لمغادرة البيت الأبيض.