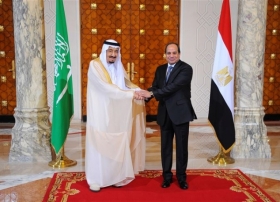الأزمة الكاشفة في مصر

العرب - رغم تحفظي على جوانب كثيرة في الجدل الدائر حاليا بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية في مصر، إلا أن التراشق بين الطرفين حمل جوانب سياسية مهمة. تراشق كشف الكثيرين عن خفايا مواقف سياسية معينة، وكيف تدار الأمور في هذا البلد، وأن عملية كسر العظم أو كسر الإرادة أصبحت نمط حياة أو أسلوبا لمؤسسات متعددة، في دولة تنشد التعافي من أزماتها.
الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الداخلية، انتهزت فرصة أمر الضبط والإحضار الذي أصدرته النيابة العامة في حق صحافيين (أحدهما تحت التمرين) لتطويع النقابة، التي بدت لقطاعات كثيرة في الدولة لها خصوصية، أو بمعنى أدق تحاول أن تصوّر أن أعضاءها “على رأسهم ريشة” في إشارة لتميزهم عن مهن أخرى، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الإسراع في سن تشريعات طال انتظارها، تنظم عمل الإعلام عموما، وفي مقدمته الصحافة التي تعاني من فوضى عارمة كبدت النظام المصري خسائر سياسية باهظة.
نقابة الصحافيين أرادت تفويت الفرصة على هدف التطويع المنتظر، ووجدت ثغرة في الطريقة التي أحضر بها ضباط الشرطة الصحافيين المتهمين في قضية جنائية، وتسويقها باعتبارها قضية رأي وحريات، ونجحت في حشد عدد كبير من أعضائها، وأصدرت بيانا رفع سقف المطالب، إلى الدرجة التي لم تكتف فيها بإقالة وزير الداخلية، بل طالبت مؤسسة الرئاسة باعتذار رسمي على أخطاء الشرطة.
هنا تكمن عقدة أخرى، فقد دخلت القضية فضاء واسعا له علاقة بالنظام وهيبته، الذي لم تكن نواياه خافية على الكثيرين لإقالة وزير الداخلية بسبب أخطاء سابقة للرجل، لكن جرى تعديل هذا الاتجاه وسط التحدي السافر الذي أظهرته نقابة الصحافيين، وهي تعلم أن عملية الإقالة والاعتذار عملية ليست سهلة.
|
|
الإقالة تستوجب موافقة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، فلم يعد القرار الخاص بها في يد رئيس الجمهورية، وكان الأجدى أن تخاطب النقابة مجلس النواب، ومطالبة الرئيس بهذا الإجراء كشفت عن “شيزوفرينيا” جديدة تنتاب قطاعا من النخبة المصرية، ففي الوقت الذي سحب الدستور صلاحية إقالة الحكومة، أو أحد أعضائها، من رئيس الجمهورية، تطالبه النقابة بالعودة إلى صلاحيات سادت في زمن اتسم بقدر كبير من الدكتاتورية.
أما اعتذار رئيس الجمهورية، فمن الصعوبة الاستجابة له تحت الضغط، لأن ذلك معناه الرضوخ لإرادة فئة، يبدو الرئيس نفسه غير مقتنع أصلا بمواقفها السياسية، مع أنه سبق وأن اعتذر طواعية، ودون أن يطالبه أحد، من نقابة المحامين عندما تعرض عضو ينتمي إليها، منذ نحو عام، للإهانة من أحد ضباط الشرطة.
المشكلة التي تغيب عن ذهن بعض الزملاء، أن رئيس الجمهورية لا يعطي أولوية لقضية الديمقراطية والحريات، وعبر عن رأيه فيهما بصورة تشي بأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، أكثر جدوى وإلحاحا، في بلد نصف سكانه (تقريبا) تحت خط الفقر، وتحيط به تحديات وتهديدات من جهات مختلفة.
لذلك، مفهوم أن يرفض التجاوب مع مطالب نقابة الصحافيين، وربما وجد في مزايدات بعض أعضائها فرصة لتأكيد صواب رؤيته، في ما يتعلق بأن الحريات بمثابة رفاهية في غير محلها الآن، ويمكن أن تجذبه إلى المزيد من المشكلات السياسية، بل يعتقد أنها قد تعيقه عن المضي قدما في المشروعات الطموحة.
هذا الأمر وجدت فيه وزارة الداخلية نافذة للقفز منها، وتأكيد قناعتها بجميع التصرفات التي بدت معالجتها لها خاطئة في نظر كثيرين، وتكريس الممارسات المرفوضة من فئة الصحافيين وغيرهم.
وهو ما جعل دوائر متباينة ترى أن هناك تشابها بين إجراءات الشرطة حاليا وتصرفاتها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجاء رفض الاستجابة من جانب الحكومة لمطالب الصحافيين، ليعزز الرؤية التي ذهبت إلى أن نظام عبدالفتاح السيسي لا يزال يحتفظ بروافد من نظام سلفه، في إدارة الأزمات والعناد والتحدي والمكابرة.
تصلح هذه النقطة كمدخل لتفسير أحد الأسباب المهمة لتكرار الوقوع في الأخطاء، في الجهاز الأمني وفي غيره من الأجهزة الحيوية، ما يقود إلى استمرار حالة الارتباك في قطاعات مختلفة، ترعـاها جماعات مصالح لها أدوات منخرطة في الجهاز البيروقراطي في الدولة المصرية. وتستخدمها كأذرع تمنع الوصول إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار، خوفا من تطبيق القانون والمحاسبة، على تجاوزات ارتكبت في مرحلة زمنية سابقة أو حالية، وربما تكون مواصلة الاهتزاز في الدولاب الإداري برمته العاصم للهروب من الوقوع تحت طائلة القانون.
الخطورة أن الأزمة كشفت أيضا عن صراع من نوع آخر يدور بين ثلاث جهات، تريد أن تنتقص من هيبة الدولة، تمهيدا لإحداث هزات عنيفة في بنيان النظام الحاكم، فإما أن يدخل مرحلة الضعف وتسهل السيطرة على مفاصله الأساسية، أو يستمر في الدوران حول أزماته ومشكلاته وتتعطل المشروعات التي يراهن عليها، ويصبح الطريق ممهدا للاعتراف بالفشل.
الجهة الأولى، أصحاب المصالح من مسؤولين وضباط كبار وإعلاميين وغيرهم، حصلوا تاريخيـا على مزايـا، مادية ومعنـوية، ويريدون الحفاظ عليها، وفي ظل مراقبتهم للطريقة التي يدير بها الرئيس السيسي البلاد، يشعرون بهواجس حيال المساس بها، عاجلا أو آجلا، ويمارسون ضغوطا لحمايتها، حتى لو عرض ذلك الدولة للخطر.
الجهة الثانية، رجال الأعمال الذين حصلوا على منافع ومزايا عديدة، ويرفضون أن تقترب منها أي جهة حكومية، ولديهم عناصر قوة، منها امتلاك بعض وسائل الإعلام، وكانت بصماتهم ظاهرة في الأزمة الأخيرة، ودخلوا على خطها عبر بوابة الصحف التي يمتلكونها، وظهرت التجليات في ارتفاع وتيرة التسخين في العناوين، ورأوا في الانحياز إلى موقف النقابة ميزة إضعاف هيبة الدولة.
علاوة على شق صف النقابة التي من المفترض أنها تدافع عن حقوق الصحافيين، الذين من يعمل منهم يعاني في صحف خاصة من صعوبات جمة، ولم تتحرك النقابة لمساعدتهم، وتكريس الانقسام داخل جدرانها يلهيها عن الالتفات إلى أزمتهم مستقبلا.
الجهة الثالثة، جماعة الإخوان المسلمين التي جاءتها الأزمة، وهي تبحث عن منافذ جديدة للضغط على النظام المصري، عقب فشل جميع محاولات الحشد الشعبي، واتخذتها مطية جديدة لتصفية جانب من الحسابات المعلقة، واستثمرت نحو 400 صحافي ينتمون إليها في دفع النقابة باتجاه المزيد من الضغط على الحكومة، ومحاولة جرّ النظام إلى التورط في الأزمة مباشرة، وكلما لاحت في الأفق ملامح تهدئة، يظهر صحافيو الجماعة مع حلفائهم من الاشتراكيين الثوريين، ويطلقون قنابل دخان للشوشرة على الوسطاء، حتى لا تبارح الأزمة القائمة مربعها القاتم.