واشنطن إذ تدفعنا دفعاً إلى «محور الشر»
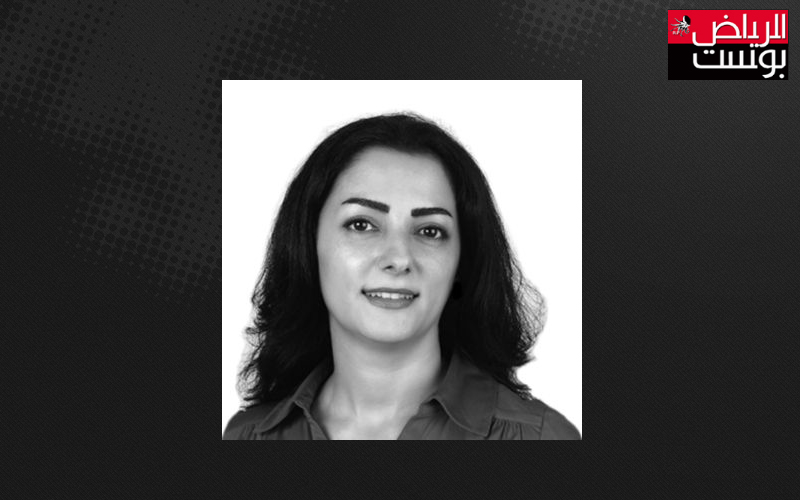
قد لا تحمل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر أكثر من دلالات رمزية ووعود لا تتحقق بالضرورة على أرض الواقع، كمثل بندقية «كلاشنيكوف» التي قدمها لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي بالمقارنة باتفاق عسكري عقد بين البلدين في 2013 بقيمة ثلاثة بلايين دولار ويتضمن مقاتلات «ميغ»، ولم ينجز بعد. فمعلوم أن عرش القيصر الروسي مضعضع اليوم أكثر من أي وقت مضى بفعل أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض أسعار النفط التي لا تبدو أنها ستعود للارتفاع قريباً وتقهقر الروبل مقابل الدولار و»تبذير» عسكري متمدد على أكثر من جبهة، فيما مصر في المقابل ليست أفضل حالاً وتحتاج لمن يسعفها اقتصادياً وليس لمن يطالبها بالتسديد. ذلك كله صحيح لا شك، إذا ما طبق على الدول «الطبيعية» حيث القرار السياسي وشكل الحكم والوصول إلى السلطة وما يترتب عن ذلك من علاقات دولية واتفاقات اقتصادية وسياسات خارجية يأتي حصيلة حراك داخلي وقرار جماعي تنتجه صناديق الاقتراع. لكنه لا ينسحب على بلدان ذات بنية سياسية «مصطنعة» وتماسك ظاهري ومفتعل، وأنظمة حكم لا تعكس بالضرورة طموح شعوبها ولا تسعى وراء مصالحهم. ففي الوقت الذي كان يمكن لأزمة اقتصادية من هذا العيار، معطوفة على المشكلات الداخلية الروسية أن تطيح حكومة في أي بلد أوروبي، لا يزال بوتين رجلاً قوياً، قادراً على فرض «نزواته» على مواطنيه والمجتمع الدولي على السواء. يكفي أن نتابع المحادثات الأخيرة في شأن أوكرانيا حيث بلغ عدد ضحايا الاشتباكات أكثر من 5 آلاف قتيل في أشهر قليلة، لندرك حجم المكاسب الروسية. فقد سلم الأوروبيون تسليماً تاماً بأن شبه جزيرة القرم، التي أطلقت فتيل النزاع، ستكون من نصيب روسيا. وعوضاً عن بحث مصيرها وتذكير بوتين بكيفية سير الأمور في هذا الجزء من العالم، انصبت المفاوضات على البحث في سبل وقف النار. وهو تماماً ما يجري مع حليف روسيا في سورية حيث التخبط لحل الأزمة الإنسانية على حساب البحث في أصل المشكلة، أي النظام السياسي. وللمفارقة، نجح بوتين أيضاً في الملف السوري في جعل موسكو، وليس جنيف، مقراً للمفاوضات بين النظام والمعارضة. وهو بذلك لم يلبِّ رغبة شريكه فحسب، بل فرض نفسه أيضاً شريكاً أساسياً في أي حل مستقبلي. لهذه الأسباب تحديداً، تكتسي رمزية التقارب الروسي- المصري خطورة أكبر مما لو كانت ثماره عسكرية محضة، وملموسة على أرض الواقع. ذاك أن «التقاء القيم» بين البلدين والتفاهم الضمني- المعلن على شكل الحكم وإدارة كل منهما لشؤون بلاده ليست بالشأن البسيط في منطقة تتلمس طريقها إلى الديموقراطـــية ( أو هكذا يفترض) بعد موجة الثورات. فصحيح أن التفات مصر إلى روسيا، قد لا يترجم بالضرورة مساعدات اقتصادية مباشرة وتسهيلات مالية لدى البنك الدولي، لكنه يعني من جملة ما يعنيه أن البلد الخارج لتوه من ثورة وثورة مضادة، مستعد أن يخرج أيضاً عن توافق دولي يربط المساعدات بشروط واضحة حول كيفية إدارة شؤون الدولة، وإجراء انتخابات شفافة، وإطلاق الحريات العامة، وإصلاح الشرطة والقضاء وغيره الكثير مما يُعتبر «شأناً داخلياً» في عرف الشريكين الجديدين. وتحمل الحفاوة والبهرجة اللتان استُقبِل بهما بوتين في القاهرة، رسالة أخرى، «رمزية» ربما بدورها، لكنها لا تقل أهمية، مفادها أن مصر قادرة على البحث عن شركاء آخرين غير مرغوبين لدى واشنطن حين تتخلف الأخيرة عن التزاماتها. فلا ننسى أن المساعدات العسكرية والمالية الأميركية لمصر لا تزال معلقة إلى موعد غير محدد، وبالنسبة إلى القاهرة، إذا كان لا بد من شريك دولي متنصل من وعوده، فالأجدى أن يكون منسحباً أيضاً من إدارة الملفات الداخلية. بهذا المعنى، الابتعاد الأميركي التام عن المنطقة لن يأتي بلا عواقب. فإذا كانت استراتيجية أوباما تقتضي الانسحاب من وحول الشرق الأوسط ريثما تجف من تلقائها، يبقى أن التنصل من التزامات سياسية وأخلاقية تجاه المنطقة لن يساهم إلا في زيادة الطين بلة وتعميق الهوة «القيمية» مع هذا الجزء من العالم. فالشوارع العربية التي خرجت تطالب بالحرية والعيش الكريم، هي ذاتها اليوم تندد بزيف «القيم الغربية» وازدواجية معاييرها. فبجردة حساب سريعة، يتبين أن سلوك واشنطن «الانطوائي» دفع المنطقة كلها إلى «محور الشر». من العراق إلى اليمن مروراً بسورية ولبنان واليوم مصر، ها هو الاصطفاف الجديد يذكر باصطفاف الحرب الباردة. وإذا كان أوباما يعوِّل على نظرية «السقوط من داخل» بفعل الضغط والعزلة التي نجحت آنذاك، فإن روسيا بوتين ليست روسيا الاتحاد السوفياتي، وكذلك إيران ودول الجوار. وقد يُفهم مما سبق أن المطلوب استعادة واشنطن دورها كـ «شرطي للعالم» كما جعلها بوش الابن، لكن ذلك يخرج عن أي منطق لاسيما أنه لم يُجدِ نفعاً في أفغانستان والعراق ولا حتى في اليمن حيث الضربات الجوية المركزة لم تقتلع «القاعدة» ولم تمنع تسلّط «الحوثيين». لكن ذلك لا يلغي أن للولايات المتحدة و»المجتمع الدولي» من خلفها، دوراً أساسياً في المساعدة في البحث عن أفق واجتراح حلول سياسية واقعية (وليست عسكرية). كما تقع عليها مسؤولية أخلاقية تجاه شعوب المنطقة التي خرجت تطالب بقيم إنسانية بسيطة ولكنْ مكلفة، وهي مما لا تقدمه طنجرة الضغط الروسية- الإيرانية التي تحشرنا فيها واشنطن. *نقلا عن جريدة الحياة اللندنية




