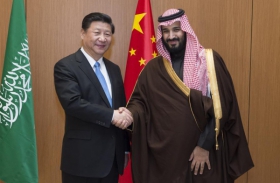اللغة الأم المطلّقة

الحياة - في ٢١ شباط (فبراير) من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للغة الأم، وقد أُشهر هذا اليوم من جانب منظمة اليونسكو عام 1999، ومن ثمّ تم إقراره رسمياً من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. تؤكد اليونسكو، في رسالتها بمناسبة اليوم الدولي للغة الأم لهذا العام ٢٠١٦، أهمية اختيار اللغات المناسبة للتعليم، وغالباً ما تكون اللغة الأم هي الأنسب في السنوات الأولى من التعليم. ترتكز الفكرة الأساسية ليوم اللغة الأم لهذا العام على «التعليم الجيد ولغة التدريس ونتائج التعلُّم»، وفق بيان المنظمة الدولية.
ثم تستطرد اليونسكو في سرد مسوغات أهمية التعليم باللغة الأم في السنوات الدراسية الأولى، للمتشككين في ذلك، بالقول: «تساهم هذه الطريقة في توصيل التعليم بطريقة مناسبة ومنصفة للناس جميعاً وبخاصة النساء والفتيات. فالمبادرة في استخدام اللغة الأم في التطبيق المباشر في حياة المتعلم اليومية تقوي الجانب المعرفي، وتضاعف فرص الانسجام بين المعلم والمتعلم وذلك بتوفير فرص للتواصل الحقيقي منذ البداية». بهذه المناسبة، أتذكّر جدلاً طويلاً وعميقاً دار في بلادي قبل سنوات حول ضرورة أو أضرار التعلّم باللغة الانكليزية في الصفوف الدراسية الأولى، وليس تعلّم اللغة الانكليزية، فشتّان بين المسلكين!
الجدل ما زال يدور، وإن خفّ ضجيجه، خصوصاً بعد أن حذّرت اليونسكو قبل سنوات من خطورة تعلّم الأطفال بلغة أجنبية، في بدايات تعليمهم على هويّتهم واندماجهم في المجتمع المحلي وقدرتهم على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطابعها المحلي. أتذكّر في هذا السياق قصة صديق التقيته مع ابنه في إحدى المناسبات، سألت الابن عن سير دراسته وهو في نهاية المرحلة الثانوية وإلى أي التخصصات سيتجه في المرحلة الجامعية وعن اهتماماته وقراءاته، لكني لاحظت ركاكة لغوية في إجاباته ومعاناة في النطق، فتريثت في مواصلة الدردشة رأفةً به!
عندما غادر الابن، التفتُّ إلى الأب فوجدت حرجاً في وجهه. قال فوراً ومن دون أن أسأله: منذ أن وُلد وضعنا له مربية غير عربية كي تتحدث معه بالانكليزية، وعندما بلغ سن المدرسة أدخلناه مدرسة أجنبية، وحتى إذا عاد إلى البيت نتحدث معه أنا وأمه بالانكليزية. كنا نستملحه في طفولته إذا تكلم بالانكليزية، ثم في سن المدرسة صرنا نفتخر عند ضيوفنا إتقانه اللغة الأجنبية، والآن حين كبر صرت أخجل أمام الآخرين من ركاكة حديثه معهم بالعربية. كنا نردّ على الذين كانوا يحذروننا في صغره بأن تحذيرهم مبالغٌ فيه لأن العربية هي لغته الأم وسيتقنها حتماً. ولا نعرف كيف مرّت الأيام سريعة حتى بلغ هذا السن وأصبح يتحرج من مجالسة أقرانه من الأقارب والأصدقاء، ليس بسبب الحاجز اللغوي فقط، بل والثقافي أيضاً إذ لا تسمح له لغته الركيكة بمتابعة الأخبار والأحداث للمجتمع المحلي، وبالتالي الدخول معهم في معترك نقاشاتهم. هذه ليست حكاية فردية، بل هي حالة كثيرين من أبناء الذوات خصوصاً!.
أبناء المهاجرين العرب لديهم معاناة شبيهة، لكن السياق التسبّبي لمشكلتهم يختلف عن سياق المقيمين في بلدانهم العربية. إذ فيما يستحق ابن المقيم العتاب على ركاكته في استخدام العربية، فإن عربية ابن المهاجر ولو كانت ركيكة فإنها تستحق التقدير والتشجيع، بسبب اختلاف الدوافع بين النموذجين. ترديد شعار (اللغة الأم) فقط لا يجدي في حماية أبنائنا من الزّيغ اللغوي! ما الفائدة إذا كانت هذه (الأم) مطلّقة، ومبعَدة عن أبنائها؟!