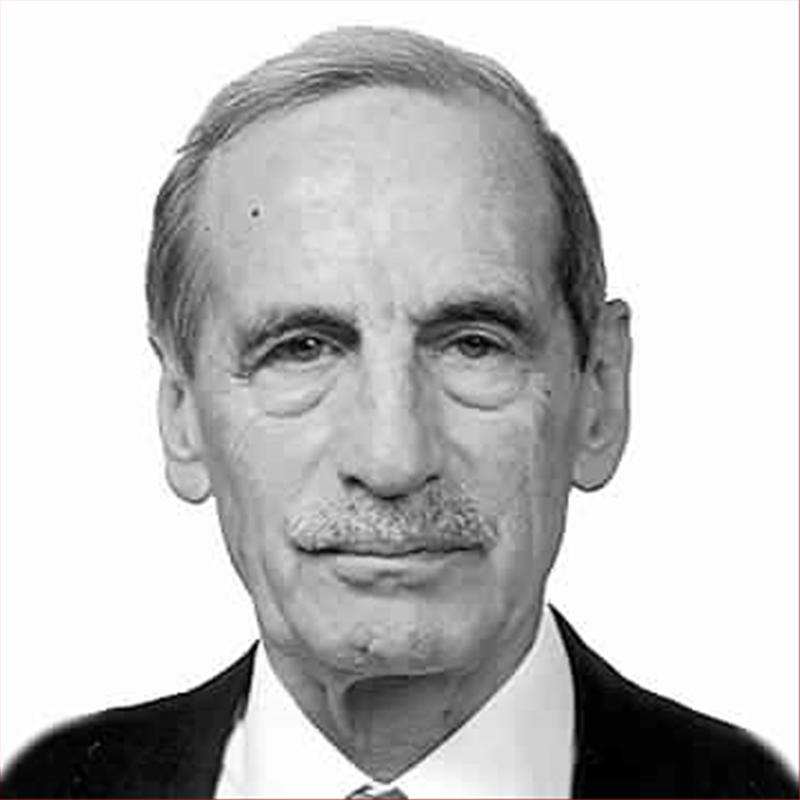عَلَمُ «داعش» في بروكسيل: من المسؤول؟

الحياة - اضطر الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى وصف خطابات المرشّح الجمهوري دونالد ترامب بأنها «بذيئة ومثيرة ضد نساء وأقليات، وضد أميركيين لا يشبهوننا أو لا يصلّون مثلنا أو لا يقترعون مثلنا». ويجد الوصف صداه لدى قادة رأي عام في أوروبا يواجهون «إخوة» لترامب يتقدّمون في صناديق الاقتراع بالاتكاء على العداء للمهاجرين المسلمين، أو على الأقل المناصرين للإسلام السياسي. وتحفل الصحافة بأخبار تعزّز التخوُّف من المسلمين، كالعثور في بروكسيل على راية «داعش»، وطعن جنديّين في تورونتو بيد شاب مسلم كندي اعتبر نفسه «منفّذاً للمشيئة الإلهية».
ويترافق التخوُّف مع القلق من تردّي الأوضاع الاقتصادية، ليشكّلا معاً رافعة لليمين المتطرّف. وها هي أسباب صعود الفاشية تكتمل في أوروبا مع وضع المسلمين موضع اليهود. ولن يواجه اليمين الشعبوي حلفاء هزموا هتلر وموسوليني متجاوزين الخلافات العميقة بين الرأسمالية والشيوعية. ليس من مركزية في عالمنا تسمح بجبهة واضحة للصراع، فقد تعدّدت الجبهات وأحدثت العولمة فراغات ثقافية تملأها الأديان المسيّسة، فتحتل مقدّم الصورة أفكار طالما اعتبرناها تاريخاً طواه النسيان.
وإذ يحرص الغربيون على التفريق بين الإسلام كدين والإسلام السياسي، فلأنهم يقرنون الدين بالإيمان ويعتبرونه شأناً شخصياً روحانياً يعزّز مشاعر المحبة ومكارم الأخلاق المتعارف عليها.
هذه النظرة هي نتاج عصر الأنوار الأوروبي الذي فصل بين الدين والدولة، وأنهى تحكُّم الكنيسة بشؤون الإنسان اجتماعاً واقتصاداً وثقافة. وتصطدم هذه النظرة اليوم بالإسلام السياسي ذي المرجعية التاريخية وليس الروحية، فتنظيمات مثل «داعش» و «القاعدة» تقدّس التاريخ الديني أكثر مما تقدّس الدين نفسه بما هو إيمان بالله. لذلك نراها ترفع راية شرائع الدول المتعاقبة في تاريخ العالم الإسلامي والتي شهدت انقلابات وانقلابات مضادة، وطالما أهدرت دم أبرياء ولم تستقر على إجماع.
في هذا السياق، يأتي السجال قبل أيام بين وزيرة الهجرة الدنماركية انغر ستويبرغ وأئمّة معتدلين نشروا مقالاً مشتركاً في صحيفة «يلانذر بوستن»، اعتبرته الوزيرة غير كافٍ لإحداث تغيير في خطاب الأئمّة الدنماركيين، ولاحظت أن أئمّة يجرّمون إقدام النساء على طلب الطلاق، وأن بعضهم يدعو إلى قتل المرتدّين ورجم المرأة الزانية.
وتحار الوزيرة بين الدين كإيمان والدين كشرائع جرى تطبيقها عبر التاريخ، وهي تريد للدنماركيين المسلمين الانسجام مع قوانين بلدهم التي تحفظ لهم حرية العبادة. قالت إن الدعوات ضد المساواة غير مقبولة في الدنمارك «ولا نقاش حول هذا الموضوع».
لكنّ النقاش يستمر في الدنمارك وغيرها من دول أوروبا وأميركا، لأن المسلمين أنفسهم لم يتوصّلوا الى نتيجة عبر 150 سنة من النقاش، وها هم في بلادهم الأصلية يطوون عصر النهضة وتجارب دولهم الحديثة، مستعيدين من التاريخ المنقضي شعارات عامة لا تهتم بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بالمأثور الثقافي الوطني ولا بالعلاقات المتبادلة بين الشعوب. وبهذا يحمل المهاجرون المسلمون مشاكلهم التكوينية معهم، ويتذرّعون بالتعدُّدية في أوروبا وأميركا ليبرّروا خصومتهم بل عداءهم للآخر المختلف ثقافياً ودينياً. علماً أن الثقافة بالمفهوم الغربي تعني المأثور الشعبي والقيميّ للوطن الأم، والدين يعني الإيمان لا التجارب الدولتية الماضية مهما أُضفِيَ عليها من قداسة.
هناك مهاجرون مارسوا هجرة ثقافية، وهم ينتمون الى نخبٍ فقدت الأمل في إصلاح مجتمعها الأصلي، وهناك آخرون يعتبرون الهجرة غزواً، كأنهم في فتوحات لم تعد مقبولة في عالم يحتاج الى التكاتف أمام تحدّيات البيئة والجوع وديكتاتوريات تختصر عنوة شعباً في رجل واحد.
عَلَمُ «داعش» في بروكسيل؟
لا تستطيع أوروبا حل المشكلة وحدها، والمؤسف أنها لا تجد عوناً من دول يعتنق مواطنوها الدين الإسلامي، تختلف على الأولويات ولا تتشارك في مواجهة الإسلام السياسي المتشدّد.
لا جبهة صراع واضحة في عالمنا. ثمة فوضى يبرز فيها التحدي الرئيسي: القضاء على التطرف الإسلامي بطرائق متنوعة لا بالحرب وحدها... قبل أن يولد بالضرورة تطرف مسيحي يدمّر حضارة حديثة بناها الأوروبيون بالعقل والدم، وبالاستعمار أحياناً.